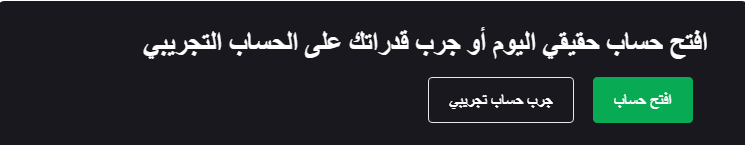في عصر «السوشيال ميديا».. من يربي أبناءنا؟!

نمو مخيف لتأثير وسائل التواصل الاجتماعي في التربية يقابله 30% فقط للأسرة!
عدم مواكبة القيم المجتمعية لتطورات التكنولوجيا يخلق فجوة يسهل بها تسيير الجيل من أي طرف
هل خرج الأمر عن السيطرة؟ سؤال من حقنا أن نطرحه اليوم. فبعد أن كانت الأسرة هي المربي الأول للطفل، لتصقل المدرسة بعدها هذا الدور، وبعد أن كان مصدر القيم والمفاهيم والأعراف هو المجتمع، وبعد أن كانت وسائل الإعلام هي مصدر المعلومة (المفلترة)، بات طفل اليوم يتنقل بلمسات أنامله بين العوالم والثقافات ويتعرض لمختلف الرسائل الإعلامية مجهولة المصدر أو الهدف. باختصار بات الأمر وكأن العالم كله يشاركك في تربية ابنك!
في السابق كان بإمكان المربي أن يعزل ابنه عن كل مصدر غير مرغوب أو موثوق. كان الأب أو الجد هو القدوة، وكانت الأعراف المجتمعية هي الحكم والمعيار. واليوم.. تغيرت القدوة، وبات صناع المحتوى غثه وسمينه قدوة، باتت الفاشنيستات قدوة، البلوغرز قدوة. لنعد إلى سؤالنا: هل خرج الأمر عن سيطرة الأسرة؟ من الذي يربي أبناءنا في عصر تحصي فيه الرقمنة حتى أنفاسنا، في عصر يؤكد الاختصاصيون أن الدور التربوي للأسرة تقلص إلى أقل من 30%.
جيل مجوف
تساؤلات ناقشناها بداية مع رئيسة قسم العلوم الاجتماعية بجامعة البحرين الدكتورة أحلام القاسمي، لنسالها بداية: من يمتلك اليوم سلطة التربية؟ الأسرة أم وسائل التواصل الاجتماعي.

تجيبنا الدكتورة أحلام: تعد تنشئة الأطفال اجتماعيا عملية معقدة وغير مضمونة. ولكن قد تكون هذه العملية سلسة ومضمونة في حال تمكنت مؤسسة واحدة فقط مثل الأسرة من تأمين مساحة خاصة وحصرية لتنشئة أطفالها فيها من دون تدخل من المؤسسات والقوى الأخرى.
لكن السؤال هو: هل هذا ممكن أصلاً؟ هل تستطيع أي أسرة اليوم، مهما أوتيت من قوة وثراء، تأمين مثل هذه المساحة؟ بالتأكيد لا، فالعالم أصبح مفتوحًا في كل الاتجاهات، ومع التقدم الكبير في تكنولوجيا الاتصال أصبح من المتعذر على الجميع تأمين مثل هذه العزلة لا داخل الأسرة ولا خارجها. إبان عصر التلفزيون كانت الأسر والمدارس دائمة الشكوى من تأثير هذا الجهاز السلبي في قيم أطفالهم وتدني تحصيلهم الدراسي. وهو جهاز واحد يمكن فتحه وإغلاقه للخلاص من شره، لكن ماذا تفعل الأسر اليوم وفي أيدي أبنائها أجهزة التواصل الذكية من هواتف نقالة إلى حواسيب لوحية موصولة بالإنترنت بحيث يستطيع أي طفل في الثانية من عمره التجول بحرية من موقع إلى آخر، ومن برنامج إلى آخر، ومن لعبة إلى أخرى، ومن فيديو إلى آخر؟
في الواقع هي أشبه بلعبة خرجت عن السيطرة بحيث لم يعد أحد قادرًا على التحكم فيها إلا في نطاق ضيق جدا، وبصعوبة كبيرة جدًّا.
وهنا تبرز مشكلة كبيرة وهي أن التطور الرقمي أسرع بكثير من التطور الجيلي. فالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي يشهدان قفزات متسارعة باتت تؤثر في الجيل وتغير لديه الكثير من المفاهيم في فترة محدودة، في حين أننا كنا في السابق بحاجة إلى ما لا يقل عن 30 عاما كي نغير مفهوما معينا لدى الجيل. ومكمن الخطر هنا أن هذه التغيرات المتسارعة ستخرج أجيالا (مجوفة) لا تمتلك رصانة ورسوخا في القيم، وبنفس الوقت لا تمتلك المرونة الكافية للتأقلم والتكيف. ففي حين أننا عايشنا الفترة التقليدية وبداية الموبايل ثم تطور وسائل التواصل الاجتماعي، وتكيفنا مع هذه التغيرات، تجد أنك لو حرمت طفلا من الجيل الحالي من وسائل التواصل الاجتماعي مثلا تحدث عنده حالة أشبه بالتجمد! وبالتأكيد كل ذلك بات يؤثر في التنشئة والتربية، فالطفل اليوم تربيه الشاشات والقنوات ووسائل التواصل والتكنولوجيا بشكل كبير. يقابل ذلك تقلص كبير من دور الأسرة.
* بالمقابل أليس هناك إيجابيات لمثل هذا التطور الرقمي والتدفق اللامحدود للمعلومات للأطفال؟
** بالتأكيد، فهذه التطورات والثورة الرقمية طوَّرت الذكاء الفردي والسلوكي والإدراك والإلمام بالمفاهيم الحديثة، وبات حتى الطفل قادرا على التعامل مع التكنولوجيا بحرفية. ولكن التحدي هنا هو ربط هذه التطورات بالقيم المجتمعية التي تمثل أداة الضبط. فلا يمكن ضبط أي مجتمع من دون قيم. وهذه التطورات إذا لم يواكبها تعزيز القيم المجتمعية لدى الأفراد ستحدث فجوة، ويتحول الفرد إلى أشبه بالآلة التي تتغذى بالمعلومات وتتصرف على أساس هذه المعلومات.
والخطورة هنا هي مصدر تغذية هذه المعلومات، فأي جهة تغذي هذه العقول ستكون قادرة على قيادتها والتأثير فيها بسهولة، لأنه مع تقلص دور القيم والأسرة، وهيمنة وسائل التواصل الاجتماعي، وما تخلق من أفراد مجوفين داخليين، هنا يسهل تصدير أي فكرة لمثل هؤلاء الأفراد، ويسهل عليهم استيعاب أي فكرة، وهذا ما يجعلهم أكثر عرضة للتأثر والاقتناع بأي أفكار غير سوية، وبنفس الوقت قد يكونون أكثر عرضة للإبداع إذا ما عاشوا في بيئة محفزة على الإبداع.
وبالتالي بقدر ما يمثل هذا التدفق الكبير للمعلومات تقدما كبيرا وحرية أوسع، بقدر ما يطرح أمامنا تحديات كبيرة. لأن الأطفال سريعو التأثر، وهذه ظاهرة صرنا نلاحظها هذه الأيام حيث صار الأطفال يرددون تعبيرات بذيئة لا يعرفون معناها، وينشدون مقاطع غنائية مسيئة، ويقومون بتصرفات غير لائقة وبعيدة عن تصرفات مجتمعنا، وكل هذا جاءهم من مقاطع التيك توك وغيرها. وليس الخوف من التأثير على هذا المستوى، بل من تحول هذا التقليد الأعمى إلى أسلوب حياة في مستقبل لهؤلاء الأطفال. فهذا الجيل بات يتقبل كل شيء، وحتى الضمير الاجتماعي الذي يمثل معيارا ومقياسا مهما لم يعد بتلك الفاعلية السابقة.
أضف إلى ذلك أننا كنا نمتلك مفاهيم واضحة ونعرف ماذا نريد. ولكن اليوم وعلى الرغم من وجود تنوع وزخم من الأفكار، باتت المفاهيم مبهمة عند الأجيال الحديثة، وليس لديها أيديولوجية ثابتة يقتنع بها، خاصة وأن التغير كما ذكرت يحدث بسرعة عالية لا تتواكب مع تغير الجيل نفسه، وهذا يؤثر حتى في اهتمامات النشء الذين باتوا يعتمدون على أشبه ما يسمى بالفكرة المعلبة السريعة.
وبنفس الوقت لم يعد هناك نموذج واحد لقدوة يمكن لأي أسرة أن تأمنه على أطفالها، بل بات هناك العديد من المؤثرين على السوشال ميديا يقدمون محتويات متناقضة، هناك مؤثر يقدم محتوى رياضيا، وآخر ألعاب الفيديو، وثالث عن المكياج، ورابع عن الغباء والهبل، وخامس عن العري، وسادس عن أساليب السرقة المبتكرة وغيرها.
* في نظرك، كيف يمكن أن نتعامل مع هذه الفجوة المتزايدة بين دور الأسرة في التربية ودور وسائل التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا الرقمية؟ هل يبدأ الأمر في الأسرة والتعليم مثلا؟
** هذه مشكلة كبيرة تتطلب تضافر جهود كل الجهات المعنية لتلافي سلبياتها من إعلام ومؤسسات تربوية ودينية وغيرها.
لكني في الواقع غير متفائلة بوجود هذا التضافر، لأن كل جهة صارت تعمل بمعزل عن الأخرى، وبعض المؤسسات صارت تجري وراء الربح والمكاسب المادية حتى لو كانت على حساب مصلحة أطفالنا. ولا يمكن الاعتماد على السوشيال ميديا لأن المؤثرين مستعدون لعمل أي شيء من أجل زيادة أعداد متابعيهم حتى لو كانت سلامة الأطفال ومستقبلهم هم الضحية للمحتوى المقدم. أنا أرى أن اهتمام الأسرة وحرصها ووعيها هو الحصن الأخير الذي يمكن أن يعمل الفارق في هذا الشأن.
وحتى المنظومة التعليمية بحد ذاتها قد تحتاج إلى إعادة صياغة لأن سرعة التطورات لم تعد تتواكب مع سنوات الدراسة الحالية.
ولكن إجمالا، إذا كان التحول تكنولوجيا، فإن عملية الضبط لابد أن تكون تكنولوجية لأنك لن تستطيع مسايرة تلك السرعة والتطور بالأساليب التقليدية، وإنما بنفس الأدوات المتطورة ومن خلال الضبط التكنولوجي. السؤال هنا من الذي يقوم بعملية الضبط التكنولوجي هذه؟ هل لدى الجيل السابق القدرة والمهارة الكافية التي تواكب ذكاء هذا الجيل؟ فالأسرة مثلا إما أن تكون في سباق مع هذه السرعة في التطورات، أو إنها تعمد إلى تخفيف هذه السرعة. لأننا في كثير من الأحيان نسهم في إدمان الأبناء الأجهزة الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي من خلال توفيرها لهم وبشكل مفتوح، أو من خلال انشغال الوالدين بأمور كثيرة وترك الطفل فريسة لهذه الوسائل.
وما يخيفني أكثر هو أن هذا الوضع يسهم في خلق جيل خارج السيطرة مستقبلا، جيل يمتلك مهارات وذكاء عاليا، ولكن هذا الذكاء غير موظف بشكل صحيح، وبالتالي يمكن التحكم فيه بسهولة من مختلف الجهات.
من هو القدوة؟
تساؤلاتنا هذه ناقشناها مع الأخصائي التربوي والمرشد الأسري الأستاذ عيسى حسين، الذي لخص المشكلة بقوله: «قبل انتشار وسائل التواصل الاجتماعي والأجهزة التكنولوجية الحديثة، كانت الأسرة هي المؤسسة الأولى لتربية الطفل، خاصة الأسرة (النووية) الكبيرة، بل حتى الأعمام والأخوال والجيران كان لهم دور في زرع القيم والعادات والتقاليد لدى الأطفال.
ولكن مع التطورات المتسارعة وانتشار البرامج ووسائل التواصل الاجتماعي والانفتاح الإعلامي، تقلص دور الأسرة، بل صار بسيطا جدا. وبعض الدراسات تشير إلى أن الطفل بات يكتسب المفاهيم من أسرته بنسبة لا تزيد على 30%، والباقي من الخارج وفي مقدمتها وسائل التواصل الاجتماعي. وهنا الخطورة، فهذه الوسائل تعكس مختلف الثقافات والعادات والشعوب والقيم.
ولكن إجمالا يمكن القول إن الأسر العربية مازالت تمتلك نوعا من السيطرة حتى الآن، ومازالت محافظة إلى حد ما على العادات والتقاليد، على الرغم من هذا الانتشار لوسائل التواصل الاجتماعي والمواد غير اللائقة. وهذا ما يؤكده المستشارون النفسيون والأسريون أن الأسرة العربية مازالت محافظة على عاداتها وتقاليدها واحترامها والمحبة والتواصل فيما بينها مقارنة بالأسر الغربية التي تعاني من انفلات كبير».
* أمام ما أشرت إليه من تراجع دور الأسرة وتنامي دور الوسائل التكنولوجية، ما إيجابيات وسلبيات هذه الحالة؟
** لا يمكن أن ننكر أن هناك إيجابيات بالطبع، ففي عصر الانفتاح ووجود مثل هذه البرامج، بتنا نلمس تواصلا بين الأطفال وأصدقائهم وأفراد الأسرة بشكل أكبر خاصة في المناسبات وبين الأفراد الذين تفصل بينهم مسافات، صحيح أنه تواصل افتراضي ولكنه مستمر طوال الوقت. وهذا أمر إيجابي أسهم في توطيد العلاقات.
وحتى في جانب التعليم وتنمية المهارات، أثبتت التجربة خلال الجائحة أن الأطفال كانوا قادرين على استثمار مثل هذه الوسائل في التعلم وتنمية المهارات. فنحن في عصر لابد فيه من استثمار وتنمية الثقافة التكنولوجية. وهذا أمر إيجابي يسهم في تطوير المفاهيم والمهارات والمعلومات عن الأبناء.
ولكن في المقابل، هناك بكل تأكيد سلبيات عديدة، لعل من أبرزها الإدمان، وهي مشكلة باتت عالمية. فالإدمان الإلكتروني من الجوانب الخطيرة، وللأسف الكثير من رواد العيادات النفسية والاستشارية في مجتمعنا خاصة الأطفال والمراهقين يعانون من الإدمان الإلكتروني. وهذا ما يسبب لهم حالات من القلق والاكتئاب والانعزال بسبب إدمان هذه البرامج والوسائل. وبكل تأكيد ينعكس ذلك سلبا على الجانب الاجتماعي والنفسي والتعليمي بل وجميع نواحي الحياة، حتى يصل الفرد إلى مرحلة العزلة والاكتئاب وانعدام الثقة لدى الطفل والغيرة بين الأطفال.
لذلك ليس مستغربا أن تؤكد العديد من الدراسات أن نسبة كبيرة من حالات الانتحار في الغرب كانت بسبب تأثير وسائل التواصل الاجتماعي.
أضف إلى ذلك أن الكثير من الأطفال من الممكن أن يتعرضوا لمواقف تغير الكثير من المفاهيم لديهم بما يتعارض مع البيئة التي نشأوا فيها، مثل مشاهدة محتويات غير لائقة أو التعرض لحالات التحرش اللفظي أو حتى الجسدي من قبل وحوش بشرية تتمكن عبر وسائل التواصل الاجتماعي من الوصول إلى الأطفال والتأثير في أفكارهم ومفاهيمهم. لذلك نسمع عن حالات كثيرة حتى في الدول العربية تعرضوا إلى مثل هذه التأثيرات. وكل ذلك يعكس الأثر الكبير لهذه الوسائل على التنشئة والتربية عند الأطفال.
* إلى جانب ما أشرت إليه من انعكاسات نفسية، إلى أي مدى يؤثر التدفق اللامحدود للمعلومات غير (المفلترة) عبر وسائل التواصل الاجتماعي في تنشئة الطفل؟
** عندما كنا صغارا كنا نتابع قناتين تلفزيونيتين أو ثلاث فقط، وكانت تقدم برامج مفيدة ومخصصة للأطفال تناسب طبيعة المجتمع وعاداته. ولكن صار العالم الآن بيد الطفل من خلال جهاز صغير، ويقوم الطفل بتصفح عشرات الصفحات والمواقع بشكل يومي، ولم تعد هناك عملية فلترة لما يقرأه أو يشاهده. ولك أن تتخيل مدى التأثير الذي سيحدث عندما يتعرض هذا الطفل وبشكل متواصل لرسائل إعلامية أو مقاطع تتعارض مع العادات ومع الدين الإسلامي وتعمل على تشويه المعتقدات والعادات.
الكثير من الأطفال تأثروا بهذه المعتقدات على الرغم من نشأتهم في أسر محافظة، وبدأ الكثير من الأطفال يتعلمون أمورا في سن مبكر نتيجة تعرضهم لمثل هذه المواد. وإلى جانب المواد الإباحية والجنسية، تأتي المواد التي تتضمن عنفا، وهذا ما جعل هذه السلوكيات تدخل حتى في المدارس، حيث يتحول الطفل إلى عنيف ومتنمر ومعتد لفظيا أو جسديا أو نفسيا. وعندما نحقق في الأمر نجد أنه تعلمها من مواقع التواصل الاجتماعي والمقاطع التي شاهدها وليس من الأسرة. وهذا ما يؤكد دور هذه الوسائل في التأثير في الطفل مقابل تراجع دور الأسرة.
* هل يمكن القول إن تأثير (القدوة) التي كان الطفل ينظر إليها سواء كان القدوة شخصا من أسرته أو مجتمعه، بدأ يندثر هو الآخر، لتحل محله شخصيات التواصل الاجتماعي بغثها وسمينها؟
** من الجوانب السلبية التي تنعكس من متابعة الأطفال لهذه الوسائل هو التقليد. وهذا التقليد قد يكون لشخصيات أو فاشنيستات أو بلوغرز ممن لا يتناسب ما يقدموه مع عاداتنا وتقاليدنا. ولكن الطفل يتابعهم ويتأثر بهم، حتى يصل إلى مرحلة يكون خارجا فيها عن السيطرة. وللأسف هذا ما نراه اليوم. فالطفل في عمر عشر سنوات صار يتحدث عن شخص يعتبره قدوة، ويريد أن يقابله ويشتري المنتجات التي يستخدمها هذا الشخص الذي يقدم أساسا محتوى فارغا خاليا من القيم والعادات. بل يروج لقيم خاطئة وسلوكيات خاطئة تتنافى مع قيم المجتمع. والطفل يتأثر بذلك.
والأسوأ من ذلك أن الأطفال صاروا يتابعون فاشنيستات أو بلوغرز من خارج إطار المنطقة العربية والإسلامية.
* وكيف يمكن أن نتعامل مع هذه المشكلة سواء من قبل الأسرة أو الإعلام أو غيرهم؟
** أولا وقبل كل شيء، القدوة الحسنة في الأسرة هي الأساس. بأن يكون الأب والأم قدوة حسنة للأطفال. فمثلا كيف يمكن منع الأطفال من إدمان وسائل التواصل الاجتماعي وهم يرون الأم والأب مدمنين عليها؟ تخيل أن الأم أو الأب يقضيان ساعات على الهاتف يتابعون الفاشنيستات والبلوغرز وغيرها، ماذا سننتظر أن يكون سلوك الطفل؟ بالتأكيد سيتأثر حتى لو لم نلاحظ.
ثم يأتي دور التوعية والتثقيف للأطفال حول مخاطر هذه الوسائل وما يجب تجنبه، وما يجب الاستفادة منه. ونرشدهم إلى شخصيات إيجابية يمكن أن يتابعوهم.
أضف إلى ذلك أنه لابد لكل أسرة أن يكون لها قوانين واضحة تتبع من الجميع، مثل تحديد ساعات محددة لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، المواقع التي يمكن الدخول إليها، الأشخاص الذين يتابعونهم، لا أن تترك الساحة مفتوحة.
ومن الضروري هنا أن نزرع الوعي الذاتي والشعور بالمسؤولية لدى الطفل نفسه، لأننا لا يمكن اليوم أن نراقب الطفل في كل لحظة وفي كل مكان. وبالتالي يكون الطفل مسؤولا عن متابعة نفسه. ويبرز الحوار الأسري هنا كوسيلة مهمة للتفاهم والإقناع مع الأطفال.
يضاف إلى ذلك أهمية وجود برامج بديلة سواء كانت ترفيهية أو توعوية أو ثقافية أو غيرها. فعندما نقلص وقت استخدام الهاتف والتعرض لوسائل التواصل الاجتماعي، لابد أن نعوض هذا الوقت ببرامج وزيارات ورحلات وتنمية هوايات وأنشطة تشغل الطفل عن هذه الوسائل. أما بالنسبة إلى الإعلام، فنحتاج إلى مواد إعلامية توعوية في مختلف وسائل الإعلام، وإلى برامج وأنشطة تستهدف توعية الأسرة بالمقام الأول بهذه المشكلة ومخاطرها وطرق التعامل معها. وإذا استطعنا توعية الآباء يمكن أن نقلل من هذه السلبيات.
وبنفس الوقت لابد أن توفر وسائل الإعلام محتوى بديلا يكون هادفا وتوعويا وأكثر تشويقا مما تقدمه وسائل التواصل الاجتماعي.
ومن الضرورة بمكان أن يكون هناك تعاون بين وسائل الإعلام والمؤسسات التعليمية والتربوية، وكذلك مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الثقافية لإيجاد برامج للآباء والأطفال وفي مقدمتها برامج توعوية حول استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.